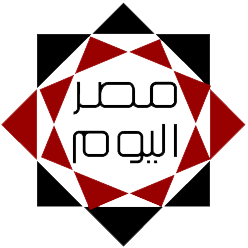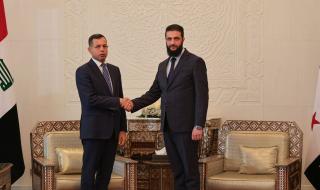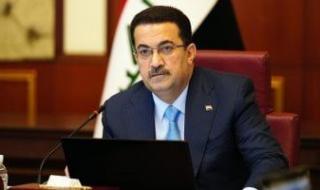بقلم ثروت الخرباوي
ثوابت لم تعد ثوابت: مراجعات فقهية بين النص والواقع
ببساطة شديدة
نستعرض بعض الأمثلة البارزة:
ملك اليمين: من تشريع قرآني إلى تجاوز تاريخي
القرآن أقرّ نظام العبيد والإماء وملك اليمين، بل سمح بمعاشرة الأمة دون زواج صريح.
“والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم” [المؤمنون: 5-6]
لكن…
• أُجمِعَ فقهيًا اليوم على إلغاء هذا النظام، وتجاوزه تمامًا.
• وقد قال الشيخ شلتوت، شيخ الأزهر: أصبح التعامل مع الرقيق اليوم حرامًا، لأن مقاصد الشريعة تقضي بالحرية والكرامة.
⸻
سهم “المؤلّفة قلوبهم”:
ذكر القرآن أن من مصارف الزكاة:
“والمؤلفة قلوبهم” [التوبة: 60]
وهم أشخاص كان يُعطى لهم من الزكاة لتأليف قلوبهم على الإسلام أو دفع شرّهم.
لكن…
رأى عمر بن الخطاب إلغاء هذا السهم، لأن الإسلام قد عَزَّ وأصبح قويًا، وقال قولته الشهيرة: لا حاجة لنا بهم.
ولم يُنكر عليه أحد من الصحابة، فكان هذا أول اجتهاد صريح في تعطيل نص قرآني عمليًا.
ومثَّل هذا بداية الفقه السياسي العملي الذي يراعي تغير الأحوال.
⸻
العبيد والإماء:
كان الفقه الإسلامي يُقرّ نظام العبيد والإماء، لكنه حثّ على العتق واعتبره من أعظم القربات.
لكن…
لم يعُد أحد من علماء المسلمين يُجيز اليوم هذا النظام، بل يُعتبر تجاوزه من مقاصد الإسلام ذاتها.
وهذا من أبلغ الأمثلة على أن ما كان “واقعًا شرعيًا” أصبح “محرَّمًا شرعًا” لتغير الزمن وتطور المفهوم الإنساني.
. الفتح لنشر الإسلام: من فخر الفقه إلى نقد العصر
اعتبر الفقه التقليدي أن من غايات الدولة الإسلامية فتح البلاد لنشر الإسلام، وكان يُعتمد على حديث:
أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله…
لكن…
راجعت تيارات كثيرة هذا المفهوم
وقال الشيخ شلتوت: لا قتال في الإسلام إلا للدفاع.وفي العصر الحديث، نُسف هذا المفهوم لصالح مبدأ “حرية الاعتقاد”، واعتبر الفتح العسكري نوعًا من الاستعمار المقنّع
الإمامة العظمى / الخلافة: من شرط الدين إلى مفهوم سياسي
كان يُعتقد أن الخلافة أو “الإمامة العظمى” من أركان الدين، كما قال الجويني والماوردي.
لكن…
بعد سقوط الخلافة العثمانية، لم يعُد هناك إجماع على ضرورة وجودها.
وأقرّ الشيخ علي عبد الرازق في كتابه “الإسلام وأصول الحكم” أن الخلافة ليست من الدين، بل من السياسة.
ودار حولها الجدل الكبير الذي غيّر مسار التفكير الإسلامي السياسي الحديث.
قتل المرتد
ما كان عليه: اعتُبر من الأحكام الثابتة، يُقتل من ترك الإسلام.
ما صار إليه: راجت مراجعات فكرية واسعة تقول لا يوجد حد لقتل المرتد وأنه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
تقييد المرأة في القضاء والولاية
ما كان عليه: المرأة لا تتولى القضاء أو الإمامة الكبرى.
ما صار إليه: أُعيد النظر في هذه الأحكام، وأفتى فقهاء معاصرون بجواز تولي المرأة القضاء، وحتى بعض المناصب السياسية الكبرى، استنادًا للعدالة والكفاءة لا النوع.
الغنائم وتوزيعها:
ما كان معمولًا به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم:
الغنائم التي يحصل عليها المسلمون في المعركة كانت تُقسَّم بين المقاتلين بعد إخراج الخُمُس لبيت المال (لله وللرسول وذوي القربى… ).
هذا ما دلّت عليه آية الأنفال بصريح النص
“واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه…” (الأنفال: 41)
اجتهاد عمر بن الخطاب:
حين فتح العراق وبلاد فارس، واجه عمر مسألة جديدة:
ماذا يفعل بأرض السواد (الأراضي الزراعية الخصبة الواسعة في العراق)؟
الجنود طالبوا بتقسيمها كغنائم – كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم .
• لكن عمر رفض تقسيم الأرض، وقال قولته الشهيرة:
“كيف أُقسمها بين هؤلاء، ويأتي من بعدهم أقوام لا يجدون شيئًا؟!”
فقرّر أن تبقى الأرض ملكًا لأهلها (الزراع الأصليين)، وتُفرض عليها خراجات (ضرائب زراعية) تُصب في بيت المال، ويُنفَق منها على مصالح الدولة والمحتاجين، أي تصبح موارد مستدامة للدولة الإسلامية.
النتيجة:
أبقى عمر على مبدأ الخُمس كما في الآية، ولكن أوقف تقسيم بقية الغنائم العقارية الكبرى (الأراضي).
• وبذلك أعاد تأويل التطبيق بما يخدم المصلحة العامة.
الخلاصة إنه
ما يُظنّ أنه “ثابت” في لحظة تاريخية، قد يكون في الحقيقة “اجتهادًا ظرفيًا”، وأن روح الإسلام، التي تدور حول العدل، والحرية، والكرامة، والرحمة، هي الثابت الحقيقي، أما الوسائل والأنظمة والأحكام التفصيلية، فهي تابعة للزمان والمكان والمصلحة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة متر مربع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من متر مربع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.