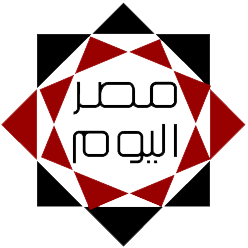غالباً ما تتشابه صور الرفاه في أذهان الكثيرين منا وهي نفس الصورة النمطية، السلبية أحياناً، التي تصف الرفاه أو رغد العيش بأنه حالة من التمتع الحسي بما تتيحه الإمكانيات المالية لكل فرد. لكن مفهوم الرفاه الإيجابي الذي تعكسه صور كثيرة في عالم اليوم، جاء خلاصة تعدد التجارب البشرية وتنوعها وسهولة الاطلاع عليها من خلال انتشار وسائل الاتصال المتطورة التي أتاحت تبادل الخبرات والتجارب بين الشعوب في زمن أقل وبلا تكاليف في بعض الأحيان.
وبينما تتسارع الأحداث وتتشابك التحديات، لم يعد السؤال المطروح في غرف الحكومات ومراكز الأبحاث مقتصرًا على كيفية زيادة الناتج المحلي أو جذب الاستثمارات. بل إن السؤال الأكثر حضورًا اليوم هو: ما الذي يجعل مجتمعًا من المجتمعات القادرة على ضمان توفير الرفاه الحقيقي، في عالم يزداد تعقيدًا وتقلّبًا؟
أولاً: الرفاه
على مدى عقود، كان قياس النجاح الوطني مرتبطًا بالنمو الاقتصادي، كأن رفاه الإنسان نتيجة ثانوية لهذا النمو. لكن تحولات العقد الماضي أعادت ترتيب الأولويات، ليصبح الإنسان في قلب المعادلة التنموية.
وأصبح الرفاه معيارًا للقوة لأن المجتمعات المتعبة لا تنتج معرفة ولا إبداعًا، حيث أثبتت التجارب أن الصحة النفسية والاجتماعية ليست رفاهية، بل شرط أساسي لدعم وتعزيز الإنتاجية والابتكار، وذلك لأن التوتر الاجتماعي يهدد استقرار الدول حيث يولد ازدياد الضغوط الاقتصادية والبطالة والتفاوتات هشاشة سياسية، بينما المجتمعات المستقرة اجتماعيًا قادرة على تخطي الأزمات دون اضطرابات، كما أن الحكومات أدركت كلفة الإهمال، ذلك أن ضعف الصحة النفسية وحده يكلف الاقتصادات مليارات سنويًا عبر انخفاض الإنتاجية وغياب الموظفين. وهناك نماذج عالمية رائدة في هذا المجال حيث اعتمدت نيوزيلندا «موازنة الرفاه» التي تقيّم السياسات وفق أثرها على جودة حياة المواطن.
وجعلت الإمارات جودة الحياة محورًا لاستراتيجيتها التنموية، من الصحة النفسية إلى المدن الذكية، وربطت فنلندا بين الرفاه المجتمعي ونظام التعليم الأكثر تقدمًا عالميًا. هذه النماذج تؤكد أن تعزيز الرفاه لم يعد توجهًا أخلاقيًا فقط، بل خيار استراتيجي لبناء دول قوية ومنتجة.
ثانيًا: القدرات
لم يعد امتلاك الموارد الطبيعية أو القوة العسكرية هو ما يمنح الدول ميزة تنافسية. في عصر الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والابتكار المتسارع، أصبحت القدرات البشرية والمؤسسية هي أساس التفوق.
فالتعليم هو المختبر الأول للقدرات حيث لم تعد أنظمة التعليم الحديثة تكتفي بنقل المعلومات، بل إن الحكومات الرائدة أصبحت تركّز على التفكير النقدي وحل المشكلات والإبداع والثقافة الرقمية والتعاون والعمل الجماعي والذكاء العاطفي.
فالعالم يتغير أسرع من قدرة المناهج التقليدية على مواكبته، والمهارات التي تضمن النجاح اليوم قد لا تكون كافية بعد خمس سنوات. ولذلك تتجه الدول إلى تعليم مرن، حيّ، قابل للتحديث المستمر.
لقد أصبح التعلم مدى الحياة سياسة مستقبلية لا غنى عنها. ومع تطور التكنولوجيا وتغير طبيعة الوظائف، لم يعد التعليم محدودًا بالمدرسة والجامعة. لذلك تبني الحكومات اليوم ما يسمى منظومات التعلم مدى الحياة التي تشمل برامج تدريب للمراحل المتقدمة من العمر ومنصات إلكترونية حكومية لتحديث المهارات وشراكات مع شركات التكنولوجيا لتأهيل العمال وبرامج إعادة مهارات للعاملين المهددين بالاستبدال بآلات ذكية. هذه السياسات توفر حماية اجتماعية، وتمنح الاقتصادات قدرة أكبر على التحوّل دون أن تتخلف شرائح واسعة من المجتمع عن الركب، ولا بد من تنامي القدرات الرقمية والمدنية. ففي عالم تزداد فيه المخاطر الإلكترونية والتضليل الإعلامي، أصبح الوعي الرقمي شرطًا لسلامة المجتمع. كذلك، فإن مشاركة المواطن في القرار العام تعزز الثقة وتسرّع الإصلاحات.ولذلك تركّز الحكومات على بناء قدرات رقمية، ووعي إعلامي، وثقافة مشاركة مدنية.
ثالثًا: الإبداع والثقافة
على الرغم من أن الحديث عن الثقافة والإبداع كان يُعتبر سابقًا «ترفًا»، فإن الدول اليوم تتعامل معه كرافعة اقتصادية واجتماعية وسياسية.
وتتنوع وسائل الصناعات الإبداعية التي تدعم اقتصاد المستقبل. فمن السينما إلى ألعاب الفيديو، ومن التصميم إلى الإعلام الرقمي، تسهم الصناعات الإبداعية بنسبة ضخمة من الناتج العالمي، وتوفر ملايين الوظائف عالية القيمة. وهي صناعات ذات أثر بعيد المدى، لأنها لا تحتاج موارد طبيعية وتعتمد على العقول ولديها قابلية هائلة للتصدير وتعزز القوة الناعمة للدول. ومن الجدير ذكره هنا أن مدناً مثل دبي، وسيؤول، ولندن، وملبورن باتت تقدم أمثلة لمدن جعلت من اقتصاد الإبداع أداة للتنافسية العالمية.
ولا ننكر أن الثقافة أصبحت رافعة للوحدة الوطنية. ففي المجتمعات المتنوعة، تلعب الثقافة دورًا أساسيًا في حماية التماسك، عبر المتاحف الوطنية والمهرجانات المشتركة والمبادرات المجتمعية والرواية الثقافية الجامعة. من هنا فإن الثقافة، بتعدد أشكالها، تحمي البلدان من الانقسام، وتعزز مشاعر الانتماء.
رابعًا: التواصل الإنساني
رغم الثورة الرقمية، يعيش العالم موجة غير مسبوقة من العزلة. تشير الدراسات إلى أن الوحدة أخطر من التدخين على الصحة العامة، وأن انقطاع الروابط الاجتماعية يقلل متوسط العمر ويزيد التوتر السياسي. لهذا أصبحت الحكومات تبحث عن وسائل لإعادة بناء الروابط بين الناس من خلال عدة مبادرات مثل إنشاء مدن تبني العلاقات الإنسانية. فالمدن الحديثة تعيد التفكير في تصميم الشوارع والحدائق والمراكز الثقافية لتقريب الناس بعضهم من بعض فكلما التقى الناس أكثر، انخفض التوتر الاجتماعي.
كما تضع الحكومات سياسات خاصة بالصحة النفسية. هناك دول عديدة أصبحت تدمج الصحة النفسية في أنظمة الرعاية الأولية، وتقدم خطوط مساعدة، وبرامج توعية في المدارس وأماكن العمل. كما تحرص على تنشيط المشاركة المجتمعية حيث تعتمد حكومات عديدة على «الموازنات التشاركية» حيث يقرر المواطنون كيفية إنفاق جزء من ميزانية مناطقهم. هذه الأدوات الصغيرة تُحدِث تأثيرًا كبيرًا في بناء الثقة.
خامسًا: الصمود
في عالم تتزايد فيه التغيرات المفاجئة، أصبح معيار القوة الحقيقي هو قدرة المجتمع على امتصاص الصدمات والتعافي بسرعة. ويعتبر الصمود عنواناً لقوة الدولة ونجاح الحكومات وهناك عدة أنواع من الصمود التي تعتمد عليها الدول الناجحة.
فهناك الصمود الاقتصادي الذي يشمل تنويع مصادر الدخل ودعم الابتكار وتعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتطوير سلاسل توريد مرنة.
وهناك الصمود البيئي الذي يعني التحول للطاقة النظيفة وإدارة ذكية للمياه وإنشاء مدن مقاومة لعوامل المناخ ووضع سياسات حماية التنوع البيولوجي
أما الصمود الاجتماعي، فتعكسه المجتمعات التي يتوفر فيها العدل، وتقل فيها الفجوات الاجتماعية، التي تكون أكثر قوة في مواجهة الأزمات.
ويعكس الصمود المؤسسي وجود مؤسسات مرنة، قادرة على اتخاذ القرار بسرعة، تعتمد التكنولوجيا، وتتيح المعلومات للمواطن، وهي مؤسسات قادرة على النجاة من الأزمات.
الإنسان أولاً وأخيراً
من خلال متابعة تجارب الدول وتحولات السياسات، يتضح أن العالم يسير نحو نموذج تنموي جديد يقوم على أربع ركائز هي رفاه الإنسان وبناء القدرات والإبداع والثقافة والصمود المؤسسي والاجتماعي.
وقد أثبتت الأزمات أن الدول التي وضعت شعوبها على رأس أولوياتها تعافت أسرع، وابتكرت أكثر، وحافظت على تماسكها.
ومع تسارع التكنولوجيا والتغير المناخي والاضطرابات الجيوسياسية، سيظل الاستثمار في الإنسان ليس مجرد خيار تنموي، بل استراتيجية وجودية. فالمجتمعات لا تزدهر بقدر ما تملك من موارد.. بل بقدر ما تمتلك من عقول، وروح، وقدرة على التكيف مع المستقبل.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.